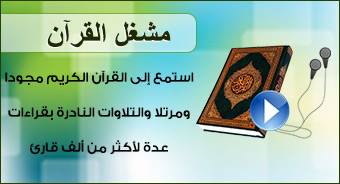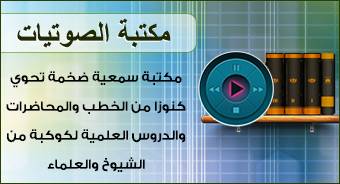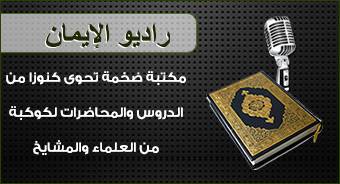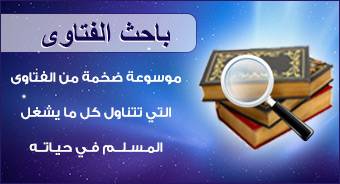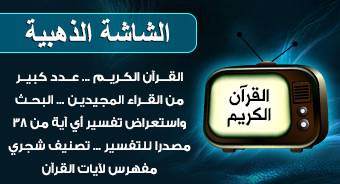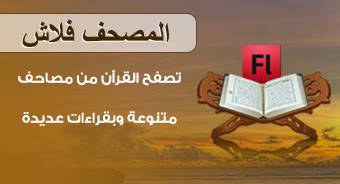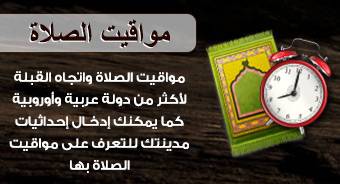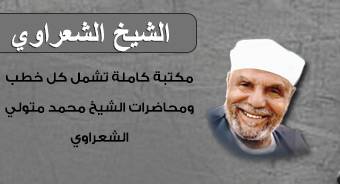|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وروي عن عكرمة {فَقَدَرْنَا} مخففة من القدرة، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم والكسائيّ لقوله: {فَنِعْمَ القادرون} ومن شدّد فهو من التقدير، أي فقدّرنا الشقي والسعيد فنعم المقدّرون.رواه ابن مسعود عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.وقيل: المعنى قدرنا قصيراً أو طويلاً.ونحوه عن ابن عباس: قدّرنا ملكنا.المهدوي: وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف.قلت: هو صحيح فإن عِكرمة هو الذي قرأ {فَقَدَرْنَا} مخفّفاً قال: معناه فملكنا فنعم المالكون، فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين؛ أي قدّرنا وقت الولادة وأحوال النطفة في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشرًا سويًّا، أو الشقيّ والسعيد، أو الطويل والقصير، كله على قراءة التشديد.وقيل: هما بمعنى كما ذكرنا.{أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26)} فيه مسألتان:الأولى قوله تعالى: {أَلَمْ نَجْعَلِ الأرض كِفَاتاً} أي ضامّة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها.وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه، ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه.وقوله عليه السلام: «قُصُّوا أظافركم وادفنوا قُلاَماتِكم» وقد مضى في (البقرة) بيانه.يقال: كَفَتُّ الشيء أكْفِته: إذا جمعته وضممته، والكَفْت: الضم والجمع؛ وأنشد سيبويه. وقال أبو عبيد: {كِفَاتاً} أوعية.ويقال لِلنِّحْي: كِفْت وكَفِيت، لأنه يحوي اللبن ويضمه قال: وخرج الشَّعبيّ في جنازة فنظر إلى الجَبَّان فقال: هذهِ كفات الأموات، ثم نظر إلى البيوت فقال: هذه كِفات الأحياء.والثانية روي عن ربيعة في النَّبَّاش قال تقطَع يده فقيل له: لم قلت ذلك؟ قال: إن الله عز وجل يقول: {أَلَمْ نَجْعَلِ الأرض كِفَاتاً أَحْيَاءً وَأَمْواتاً} فالأرض حِرْز.وقد مضى هذا في سورة (المائدة).وكانوا يسمّون بَقِيع الغَرْقد كَفْتة، لأنه مقبرة تضم الموتى، فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم والأموات في قبورهم.وأيضاً استقرار الناس على وجه الأرض، ثم اضطجاعهم عليها، انضمام منهم إليها.وقيل: هي كِفات للأحياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض؛ إذ لا ضَمّ في كون الناس عليها، والضَّمّ يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه.وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض، أي الأرض منقسمة إلى حيّ وهو الذي ينبت، وإلى ميت وهو الذي لا ينبت.وقال الفراء: انتصب {أَحْيَاءً وَأَمْواتاً} بوقوع الكِفات عليه؛ أي ألم نجعل الأرض كِفات أحياء وأموات.فإذا نوّنت نصبت؛ كقوله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً} [البلد: 14-15].وقيل: نصب على الحال من الأرض، أي منها كذا ومنها كذا.وقال الأخفش: {كِفَاتًا} جمع كافتة والأرض يراد بها الجمع فنعتت بالجمع.وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر.ويقال: انكفت القومُ إلى منازلهم أي انقلبوا.فمعنى الكِفات أنهم يتصرفون على ظهرها وينقلبون إليها ويدفنون فيها.{وَجَعَلْنَا فِيهَا} أي في الأرض {رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ} يعني الجبال، والرواسي الثوابت، والشامخات الطوال؛ ومنه يقال: شمخ بأنفه إذا رفعه كبراً.قال: {وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتاً} أي وجعلنا لكم سُقْيا.والفُرَات: الماء العذب يشرب ويسقي منه الزرع.أي خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات.وهذه الأمور أعجب من البعث.وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة الفُرَات والدّجلة ونهر الأردن.وفي صحيح مسَلم سيحان وَجَيْحان والنيل والفُرات كلّ من أنهار الجنة.قوله تعالى: {انطلقوا إلى مَا كُنتُمْ به تُكَذِّبُونَ} أي يقال للكفار سيروا {إلى مَا كُنتُمْ به تُكَذِّبُونَ} من العذاب يعني النار، فقد شاهدتموها عياناً.{انطلقوا إلى ظِلٍّ} أي دخان {ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ} يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب.وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب.ثم وصف الظلّ فقال: {لاَّ ظَلِيلٍ} أي ليس كالظلّ الذي بقى حرّ الشمس {وَلاَ يُغْنِي مِنَ اللهب} أي لا يدفع من لهب جهنم شيئاً.واللهب ما يعلو على النار إذ اضطرمت، من أحمر وأصفر وأخضر.وقيل: إن الشُّعَب الثلاث هي الضريع والزُّقُّوم والغِسْلين؛ قاله الضحاك.وقيل: اللهب ثم الشرر ثم الدخان؛ لأنها ثلاثة أحوال، هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت واشتدت.وقيل: عُنُق يخرج من النار فيتشعب ثلاث شعب.فأما النور فيقف على رؤوس المؤمنين، وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين، وأما اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين.وقيل: هو السُّرَادق، وهو لسان من نار يحيط بهم، ثم يتشعب منه ثلاث شعب، فتظللهم حتى يُفْرَغ من حسابهم إلى النار.وقيل: هو الظلّ من يَحْموم؛ كما قال تعالى: {فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لاَّ بَارِدٍ وَلاَ كَرِيمٍ} [الواقعة: 42-44] على ما تقدّم.وفي الحديث: «إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ لباس ولا لهم أكفان فتلحقهم الشمس وتأخذ بأنفاسهم ومُدَّ ذلك اليوم، ثم ينجّي الله برحمته من يشاء إلى ظلّ من ظلّه فهنالك يقولون: {فَمَنَّ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السموم} [الطور: 27] ويقال للمكذبين: {انطلقوا إلى مَا كُنتُمْ به تُكَذِّبُونَ} من عذاب الله وعقابه {انطلقوا إلى ظِلٍّ ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ}». فيكون أولياء الله جلّ ثناؤه في ظلّ عرشه أو حيث شاء من الظلّ، إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكل فريق إلى مستقرّه من الجنة والنار.ثم وصف النار فقال: {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كالقصر} الشرر: واحدته شررة.والشرار: واحدته شرارة، وهو ما تطاير من النار في كل جهة، وأصله من شَرَّرَتُ الثوبَ إذا بسطته للشمس ليجفّ.والقصر البناء العالي.وقراءة العامة {كَالْقَصْرِ} بإسكان الصاد: أي الحصون والمدائن في العِظم وهو واحد القصور.قاله ابن عباس وابن مسعود.وهو في معنى الجمع على طريق الجنس.وقيل: القصر جمع قَصْرةٍ ساكنة الصاد، مثل جَمْرَة، وجَمْرٍ وتَمْرة وتَمْر.والقصرة: الواحدة من جَزْل الحطب الغليظ.وفي البخاريّ عن ابن عباس أي {تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصَرِ} قال كنا نرفع الخشبَ بقَصَرٍ ثلاثة أذرعٍ أو أقلّ، فنرفعه للشتاء، فنسميه القَصَر.وقال سعيد ابن جُبير والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقُطِع.وقيل: أعناقه.وقرأ ابن عباس ومجاهد وحُميد والسّلميّ {كَالْقَصَرِ} بفتح الصاد، أراد أعناق النخل.والقَصَرة العنق، جمعها قَصَر وقَصَرات.وقال قتادة: أعناق الإبل.وقرأ سعيد بن جُبير بكسر القاف وفتح الصاد، وهي أيضاً جمع قَصْرة مثل بَدْرة وبِدَر وقَصْعة وقِصَع وحَلْقَة وحِلَق، لحِلقِ الحديد.وقال أبو حاتم: ولعله لغة، كما قالوا حاجَة وحِوَج.وقيل: القَصْر: الجبل، فشبه الشرر بالقَصْر في مقاديره، ثم شبهه في لونه بالجمالات الصُّفْر، وهي الإبل السود؛ والعرب تسمى السُّود من الإبل صُفْراً؛ قال الشاعر: أي هنّ سود.وإنما سُمّيت السود من الإبل صُفراً لأنه يشوب سوادها شيء من صُفرة؛ كما قيل لِبيض الظباء: الأدْم؛ لأن بياضها تعلوه كُدْرة: والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السود، لما يشوبها من صُفْرة.وفي شعر عِمْران بن حِطَّان الخارجيّ: وضعَّف الترمِذِيّ هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغة، أن يكون شيء يشوبه شيء قليل، فنسب كله إلى ذلك الشائب، فالعجب لمن قد قال هذا، وقد قال الله تعالى: {جِمَالاَتٌ صُفْرٌ} فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة.ووجهه عندنا أن النار خُلِقت من النور فهي نار مضيئة، فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار، حشا ذلك الموضع بتلك النار، وبعث إليها سلطانه وغضبه، فاسودت من سلطانه وازدادت حِدّة، وصارت أشدّ سواداً من النار ومن كل شيء سواداً، فإذا كان يوم القيامة وجيء بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف، غضباً لغضب الله، والشرر هو أسود، لأنه من نار سوداء، فإذا رمت النار بشررها فإنها ترمي الأعداء به، فهنّ سود من سواد النار، لا يصل ذلك إلى الموحدين؛ لأنهم في سرادق الرحمة أحاط بهم في الموقف، وهو الغمام الذي يأتي فيه الربّ تبارك وتعالى، ولكن يعاينون ذلك الرمي، فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضب عنه في رأي العين منهم حتى يروها صفراء؛ ليعلم الموحدون أنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه.وكان ابن عباس يقول: الجِمالات الصُّفر: حِبال السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال.ذكره البخاري.وكان يقرؤها {جُمَالاَتٌ} بضم الجيم، وكذلك قرأ مجاهد وحُميد {جُمَالاَت} بضم الجيم، وهي الحبال الغلاظ، وهي قُلُوس السفينة أي حبالها.وواحد القُلُوس: قَلْس.وعن ابن عباس أيضاً على أنها قطع النحاس.والمعروف في الحبل الغليظ جُمَّل بتشديد الميم كما تقدم في (الأعراف).{وجُمَالاَت} بضم الجيم: جمع جِمالة بكسر الجيم مُوَحّدًا، كأنه جمع جَمَل، نحو حَجَر وحجارة، وذَكَر وذِكَارة.وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى والجَحْدَريّ {جُمَالة} بضم الجيم موحداً وهي الشيء العظيم المجموع بعضه إلى بعض.وقرأ حفص وحمزة والكسائي {جِمَالة} وبقية السبعة {جِمَالاَت} قال الفراء: يجوز أن تكون الجِمالات جمع جِمال كما يقال: رجل ورِجال ورِجالات.وقيل: شبهها بالجمالات لسرعة سيرها.وقيل: لمتابعة بعضها بعضاً.والقَصْر: واحد القصور.وقَصْر الظلام: اختلاطه.ويقال: أتيته قصراً أي عَشِيًّا، فهو مشترك؛ قال: مسألة في هذه الآية دليل على جواز ادخار الحطب والفحم وإن لم يكن من القوت، فإنه من مصالح المرء ومغانِي مفاقِرِهِ.وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في غير وقت حاجته؛ ليكون أرخص وحالة وجوده أمكن، كما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يدّخر القوت وفي وقت عموم وجوده من كسبه وماله، وكل شيء محمول عليه.وقد بين ابن عباس هذا بقوله: كنا نعمد إلى الخشبة فنقطعها ثلاثة أذرع وفوق ذلك ودونه وندّخره للشتاء وكنا نسميه القَصَر.وهذا أصح ما قيل في ذلك والله أعلم. اهـ.
|